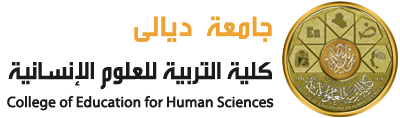رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش البحث اللغوي عند الدكتور غالب المطلبي
رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش البحث اللغوي عند الدكتور غالب المطلبي
ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة بـ (البحث اللغوي عند الدكتور غالب المطلبي ) .
وتهدف الدراسة التي تقدمت بها الطالبة ايمان علي سعدون ابراهيم ، وأشرف عليها الاستاذ الدكتورة غادة غازي عبد المجيد ، الى تسليط الضوء على البحث اللغوي عند الدكتور غالب المطلبي .
وتوصلت الدراسة استنتاجات عدة منها ان سيرَةَ هذا العالِمِ العِلمِيَّة كَشَفَتْ عَن أَهَمِّ الوظائِفِ الأكادِيمِيَّةِ والإدَارِيَّةِ وَالمَهامِّ واللِّجانِ الّتِي حَصَلَ عليها ، من حيث إنَّ هذه هي الرِّسَالَة الاكاديميَّة الأولى الّتِي تُعنى بدراسَةِ هذا الرّجل العالِمِ، وتَمَّ في هذه الرِّسَالَةِ إحصاءُ جميعِ ما ألَّفَهُ وَحَقَّقَهُ الدّكتور ، وقد بلغت تسعة كتب وثلاثة أبحاث، فضلاً عن مؤلَّفاتِهِ الأدَبِيَّةِ ، ويُعَدُّ الدّكتور أوَّل باحِثٍ عراقِيٍّ تحدَّثَ عن الفونيم، وهو الَّذِي صَرَّحَ لي بذلكَ في اتِّصالٍ جرى بيني وبينه ، وإنَّ مُصطلحَ (لغة) و(لهجة) – بحسب رأي الدّكتور – مُصطلحان مُترادفانِ عند القُدماءِ، بيد أنَّ القُدماءَ قد تضاءل عندهم مُصطلح (لهجة) وفشا مُصطلح (لغة) في مؤلَّفاتِهِم، وهُناك صعوبة كبيرة واضحة لدراسة الخصائص الصَّوتِيَّة لأيَّةِ لهجَةٍ قديمَةٍ، وهذه الصّعوبَةُ تتأتَّى من أنَّ اللّغة أو اللّهجة لم تَصِلْنَا منطوقَةً، وَإنَّمَا وَرَدتْ مكتوبَةً، فضلاً عن عدم اهتمام القُدماءِ بِاللَّهجَاتِ القديمة؛ إذ إنَّها من وجهة نظرهم تُخِلُّ بِاللّغة العَرَبِيَّةِ الفُصحى وتسبِّبُ لها الضّياع.
وبينت الدراسة ان هُناك عِدَّةُ ظواهر صَوتِيَّة في لهجة تميم عندما نوازنها مع لهجاتنا الحديثة كالعِراقِيَّةِ والمصرِيَّةِ والكُوَيتِيَّةِ مثلاً، نَجِدُها موجودَةً فيها، كالعنعنة وإبدال الياءِ من الهمزَةِ وإبدال الجيم والياء وغيرها، وإنَّ قلبَ الجيم ياءً ليست ظاهرة من ظواهر لهجة تميم وَإنَّمَا كان محدَّدًا في كلمات قليلة ومعدودة كـ(شجرة) و(صهريج)، وكما هو معروف عندنا أنَّ الكلمة أو الكلمتين لا تشكِّلُ ظاهرةً يُمكنُ تعميمها، ويرى الدّكتور أنَّ الهمز والمخالفة والتّخفيف والإتباع والمعاقبة هي خصائص صرفيَّة ظهرت بسبب ميول وتغيُّرات صَوتِيَّة ، ووافق الدّكتور سابقيه من علماء اللّغة في أنَّ اللُّغَات الإنسَانِيَّة على وجه الأرض كثيرة ولا يُمكن إحصاؤها، وكان الدّكتور شديد الاهتمام باللُّغات السَّامِيَّة، إذ كان شديد الاهتمام بفصائل هذه اللّغات والظّواهر النَّحوِيَّة الموجودة فيها كالإعراب والاسم والفعل والتّعريف والتّنوين والمُنادى.
وأكَّدَت الدراسة أنَّ لم يَكُنْ في رأيِهِ النّهائيّ في نشأة اللّغة مُستقِرًّا على أنَّ اللّغة نشأت بفعل التَّواضُعِ والاصطلاحِ، إذ كان في البداية من أصحابِ نظرِيَّةِ المواضَعَةِ ثُمَّ عَدَلَ بعد ذلك إلى نَظَرِيَّةِ الوحي، لرؤيَتِهِ قدسِيَّة هذه اللّغة الشَّريفةِ وأنَّها ليست من صُنعِ البَشَرِيَّةِ، ثُمَّ بعد ذلك يقف مُتَحَيِّرًا بين هاتين النَّظرِيَّتَينِ ، ولم يكُنْ مُصطلَح المدارسِ اللُّغَويَّةِ الغَربِيَّةِ مُصطلحًا مُستَقِرًّا عند عُلماءِ اللّغة المُعاصِرينَ العرب والغرب، فمَرَّةً يُطلقونَ عليه اتّجاه ومرَّةً مدرسة ومرَّةً أخرى نَظَرِيَّة ، وهناك تشابه كبير بين نَظَرِيَّة الدّكتور في كتابه (في النَّحو العربي نقد وتوجيه) الّتِي تدعو إلى إبعادِ نَظَرِيَّةِ العاملِ عن النَّحو العربي وإحلال مبدأ الوظيفة النَّحوِيَّة ووظيفة النَّحوِيّ محلّها ونَظَرِيَّة المدرسة الوَظيفِيَّةِ الغَربِيَّةِ (مدرسة براغ) في المبادئ نفسها، ولكنَّ الدّكتور يُبرِّرُ للدّكتور بعدم اطّلاعه على هذه النَّظَرِيَّةِ الغَربِيَّةِ وأنَّهُ أخذ مبادِئَهُ من تُراثِنا العربيّ.